تقرير تحليلي – وطن – منذ تسعينيات القرن الماضي، ومع صعود جيل جديد من الحكّام في الخليج، بدأت كلٌّ من قطر و**الإمارات** في شقّ طريقين متمايزين عن الدور القيادي التقليدي الذي افترضته السعودية لنفسها داخل مجلس التعاون الخليجي. ورغم أن أزمة وحصار قطر عام 2017 شكّلا الذروة العلنية لهذا التباعد، فإنهما لم يكونا سوى انعكاسٍ لتحوّلات أعمق وأقدم.
جذور التباعد… كما تشرحها إيما سوبرييه
وترى الباحثة الفرنسية إيما سوبرييه أن الخلافات الخليجية لم تنشأ فجأة، بل هي نتيجة مسار تراكمي بدأ منذ نهاية الثمانينيات. وفي كتابها
Qatar and the United Arab Emirates: Diverging Paths in the Gulf
وتوضح سوبرييه أن النزاعات التي بدت ظرفية—من خلافات حدودية ومحاولات انقلاب وصولًا إلى الأزمة الخليجية—كانت في حقيقتها أعراضًا لتحولات بنيوية أعمق، تتعلق بحجم الدولة، وطبيعة بنيتها السياسية، ومركزية القرار في ما تُسمّيه “الدولة الأميرية”.
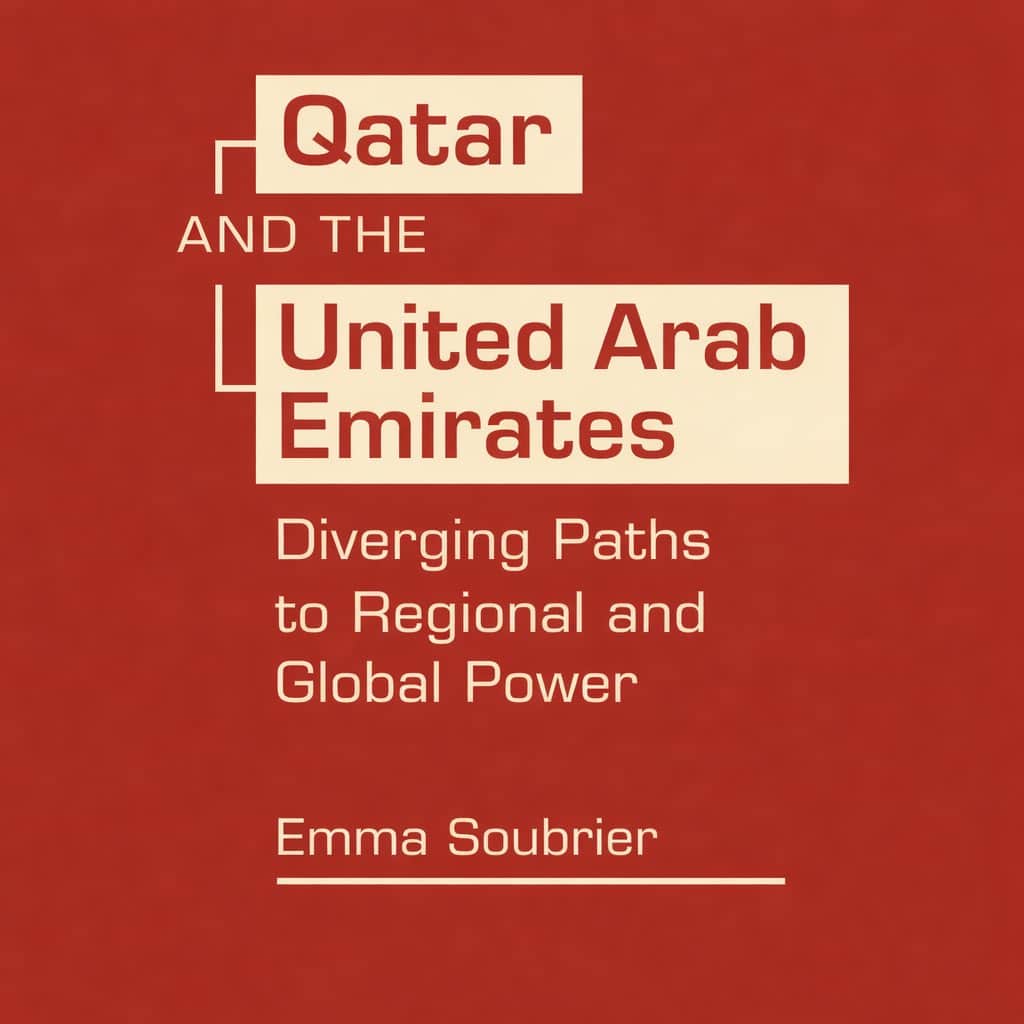
وبحسب هذا التحليل، فإن ابتعاد قطر والإمارات عن السعودية لم يكن تمرّدًا سياسيًا عابرًا، بل إعادة تعريف للدور الإقليمي خارج مظلة القيادة السعودية.
من صدمة الكويت إلى سؤال الحماية
وشكّل غزو العراق للكويت عام 1990 لحظة مفصلية دفعت دول الخليج إلى مراجعة حساباتها الأمنية. ثم جاءت هجمات 11 سبتمبر لتطرح سؤالًا وجوديًا داخل العواصم الخليجية: ماذا لو امتنعت الولايات المتحدة عن التدخل لحماية المنطقة؟
وهذا السؤال عزّز القناعة بضرورة امتلاك أدوات مستقلة للدفاع والنفوذ، دون الاتكال الكامل على الرياض أو الغرب.
لماذا كان التباعد مع السعودية تحديدًا؟
وتنظر الرياض إلى نفسها بوصفها القائد الطبيعي لمجلس التعاون، وغالبًا ما تتوقع من أعضائه الاصطفاف خلف رؤيتها في ملفات كبرى، مثل معارضة الإسلام السياسي والحفاظ على استقرار الأنظمة الملكية. غير أن الدوحة وأبوظبي رفضتا هذا الدور الأبوي، لكن بمنهجين مختلفين تمامًا.
- قطر اختارت مسار القوة الناعمة وتوازن المحاور؛ فأقامت علاقات متوازنة مع إيران وتركيا، وفتحت قنوات مع حركات الإسلام السياسي، وكرّست نفسها وسيطًا إقليميًا في ملفات معقّدة من غزة إلى أفغانستان.
- الإمارات، في المقابل، ذهبت إلى بناء قوة صلبة، فانخرطت ميدانيًا في اليمن، ودعمت حلفاء عسكريين في المنطقة، ووسّعت نفوذها عبر شبكة موانئ تمتد من البحر الأحمر إلى القرن الإفريقي، وربطت حضورها العالمي باتفاقيات إبراهيم والتكنولوجيا واللوجستيات.
الطاقة تفسّر السياسة
ويفسّر اختلاف نموذج الطاقة جزءًا كبيرًا من هذا التباين. فـقطر، باعتبارها أكبر مصدّر للغاز المسال، تفرض عليها عقودها طويلة الأجل الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع اللاعبين. أما الإمارات، فهي منتج نفطي متنوع يعتمد على سلاسل لوجستية وموانئ ومناطق حرة، ما يدفعها إلى تأمين العقد البحرية وممرات التجارة.
وهكذا، تبنّت قطر شعار “الصداقة مع الجميع”، بينما ركّزت الإمارات على السيطرة على المفاصل. وفي المقابل، تعرّف السعودية أمنها من خلال العمق البري والحدود، وتسعى إلى يمنٍ موحّد يحيّد الحوثيين، بينما ترى الإمارات اليمن حزام موانئ وأدوات نفوذ عبر وكلاء محليين. ويتجسّد هذا التباين اليوم في اليمن والسودان والبحر الأحمر.
من خلاف ملفات إلى صدام مراكز
والمرحلة الأحدث من التنافس جاءت مع رؤية السعودية 2030، التي نقلت الخلاف من مستوى الملفات إلى مستوى المراكز الإقليمية. فاشتراط المقرات الإقليمية للشركات، وإطلاق شركة طيران وطنية ثانية، وبناء مناطق لوجستية جديدة، كلها خطوات تزاحم دبي مباشرة. وفي إطار أوبك+، يظهر احتكاك بنيوي: أبوظبي تريد رفع خط أساس إنتاجها لترجمة طاقتها الفائضة إلى نفوذ وإيرادات، بينما تمسك الرياض بمقود توازن السوق.
البنية و«الدولة الأميرية»
وتوضح سوبرييه أن السبب الهيكلي للاختلاف بين المسارين يكمن في البنية: قطر دولة صغيرة موحّدة، إمارة واحدة، بينما الإمارات اتحاد فيدرالي يحتاج إلى بناء هوية وطنية غالبًا عبر القوات المسلحة والصناعات الدفاعية. ومنذ إطلاق معرض «آيدكس» عام 1993 ثم بروز مجمّع الصناعات الدفاعية EDGE، ظهر الفارق بوضوح:
قطر أعطت الأولوية للشرعية والوساطة، والإمارات ركّزت على القوة العسكرية.
الخلاصة
لن يُحسم مستقبل الخليج بالشعارات، بل بالموانئ والحدود والعقود. فإذا حافظت الدوحة على توازنها الناعم في بيئة تتجه نحو التصلّب، واستطاعت أبوظبي إدارة شبكتها من دون كلفة استنزاف، فقد نشهد خليجًا متعدّد المراكز لا متمحورًا. أمّا إذا اختلّ أحد المسارين، فقد يعود ثقل القرار إلى الرياض—لا بهيمنة الماضي، بل بقوة الأمر الواقع.
اقرأ أيضاً:












